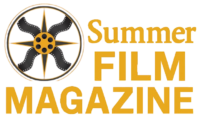ليلتانِ وعيدٌ ليس واحدًا في السينما المصرية من ١٩٤٩ إلى ٢٠٢٤
العيد فرحة.. نعم؛ أجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد!
لكن هل اختلفت ليلة العيد والاحتفاء بها في السينما المصرية منذ ١٩٤٩م. حتى ٢٠٢٤م.؟!
بين فيلم يحمل اسمها من إخراج حلمي رفلة وبطولة شادية وإسماعيل يس وشكوكو وغيرهم، وفيلم يحمل نفس الاسم من إخراج سامح عبدالعزيز وبطولة عدد كبير من الممثلين والممثلات المخضرمين والشباب على رأسهم يسرا وسميحة أيوب وسيد رجب.
الفيلم الذي يدور أو يفترض أنه يدور في ليلة واحدة قالب لم يعد جديدًا وظف كثيرًا في السينما العالمية والعربية، وبالطبع تحتاج تلك الليلة أن تكون ليلة شديدة التميز، ليلة تشمل أحداثًا كثيرة تدفع البطل إلى أماكن متنوعة وتحفز الإيقاع بحيث يصبح الزمن السينمائي وزمن الفيلم متوافقان فيرضى المشاهد الذي اعتاد أن يرى حياة كاملة في ساعة ونصف أو ساعتين وهو يرى في نفس المدة الزمنية أحداثًا وصراعًا حدث في ليلة واحدة، وربما في زمن لم يتعد مدة عرض الفيلم نفسه. لذلك يقع الاختيار دائمًا على ليالي مثل ليلة رأس السنة مثلما نجد في فيلم (ليلة ساخنة) أو ليلة الزفاف في الفيلم الذي يحمل هذا الاسم نفسه، أو ليلة العيد التي تكرر ظهورها في السينما المصرية سواء ضمن الأحداث في بعض المشاهد كما رأينا مثلا في فيلم عسل أسود عام ٢٠٢٠م. أو فيلم دنانير الذي عرض لأول مرة عام ١٩٤٠م. وغنت فيه أم كلثوم أشهر أغاني العيد وليلته: “يا ليلة العيد، آنستينا وجددتي الأمل فينا يا ليلة العيد”، وأيضًا تأتي كمحور للأحداث مثلما نجد هنا في فيلمينا اللذين يحملان اسم (ليلة العيد) وهما طبعًا ليسا عن قصة واحدة لكنهما بالطبع عن حدث واحد يتكرر كل عام، يرتقبه الناس على أمل الفرج وفسحة النفس والترويح عن الذات بالراحة والتزاور والتراحم. لكن الارتقاب قد يكون أحيانًا في حد ذاته عذابًا، انتظار الفرح ليس حدثًا سعيدًا دائما بل قد يكون عكس ذلك. قد يكون معاناة مثلما هو حال الصبر دائمًا مر، لكن ميزة العيد عند الناس أنه لا بد سيأتي في ميعاده وهذا في حد ذاته مدعاة للرضا والسرور.

قد يدهشك عند مشاهدة الفيلم الأول الذي عرض عام ١٩٤٩م. أنك لن تجد أثرًا لليلة العيد تمامًا، لا مظاهر لما يمكن اعتباره عيدًا، لا إسلاميًا ولا مسيحيًا ولا يهوديًا وهي الديانات الثلاثة التي كانت شائعة في ذلك الوقت في مصر، وحتى لم يعرض الفيلم ضمن ما يطلق عليه أفلام العيد لأنني وجدت ميعاد عرضه ١٢ ديسمبر وكان مواكبًا لنهايات شهر (صَفَر) هجريًا، يعني ليس وقت عيد الأضحى ولا الفطر ولا حتى رأس السنة، ومع ذلك تجد العيد حاضرًا بفرحته وبهجته طوال الفيلم.
اختار صناع الفيلم قالبًا يجمع بين الموسيقية والكوميديا، وهما من جهة قالبان تميز فيهما السينمائيون المصريون دائمًا، ولولا الجري دائمًا وراء التقاليع الغربية والنظر إلى السينما الأمريكية والأوروبية كمصدرين للتعلم ومنهجين للعمل لا يجب الحيد عن توجهاتهما، لكان هذا الشكل السينمائي الأقرب لروح المجتمع المصري والأكثر ترشحًا ليكون أسلوب ومدرسة المصريين الخاصة، لكننا للأسف اعتدنا أن لا نكمل الطرق إلى آخرها.
القالب الموسيقي الكوميدي هو أكثر الأشكال السينمائية إشاعة للبهجة، بسبب هذا القالب كان العيد موجودًا رغم أن أحدًا لم يشر إليه إلا على استحياء في الأغنية التي يفتتح بها الفيلم وتقول كلماتها:
“العيد العيد.. آهو جانا العيد
إلحق.. قَدِّم.. قرَّب.. إجري
خش اتفرج ع التحبيشة
شوف الوحش السبع الغجري
قاعد مجعوص يشرب شيشة
والنمر بيلعب كونكان
والضبع بيلبس فستان
والواد كتكوت.. بيشيل في حديد
الليلة العيد”.
هذه الأغنية يغنيها رجلان يرتديان زي مهرجين وتحيط بهما راقصات ترتدين ملابس رقص مكشوفة لا توحي تمامًا بما قد تعنيه ليلة العيد من فرحة مرتبطة بالشعائر الدينية، كما أن هذه المجموعة من الراقصات والمهرجين واللاعبين تتولى دعوة الجمهور للدخول إلى مسرح صغير يعرض مسرحية روميو وجولييت بصياغة غنائية كوميدية، وذلك الأسلوب في الدعاية كان شائعًا في الماضي وظل مستخدمًا حتى وقت قريب في الموالد للدعاية للمسارح الشعبية، باستثناء وجود الراقصات طبعًا.
من هنا يبدأ الفيلم ويأخذنا في صراع لطيف وأزمان ظريفة حيث ثلاثة أشقاء: شادية الفتاة الشقية الصغيرة التي لم تكن في الحقيقة تخطت التاسعة عشر من عمرها وهو نفس العمر الذي كانت تعيشه البطلة التي تشاركها أيضًا في كونها فنانة شاملة تمثل وتغني وترقص (نوعًا ما)، وأخواها الأكبر منها ببضع سنين هما اثنين من الممثلين متعددي المواهب أيضًا: (إسماعيل يس) و(محمود شكوكو)، كلاهما عرف كمنولوجيست يؤدي المونولوجات التي تتميز بخفة الروح والسخرية اللاذعة، ويلقون النكات، وأيضا هما من أهم الممثلين الكوميديين ذوي الجمهور العريض، كما أنهما يؤديان الاستعراضات بمهارة مقبولة.
الأشقاء الثلاثة يعملون في أحد المسارح الاستعراضية، لكن مدير المسرح يطردهم بعد أن يوسعوه ضربًا لأنه تجرأ وغازل الأخت الجميلة، وهنا تبدأ رحلة البحث عن عمل جديد توقعهم في طريق ثري شاب ساذج يحاول بعض الأشرار تزويجه لأختهم بهدف الاستيلاء على أموال أبيه الباشا، وتستطيع فرقة المغنيين إنقاذه فينتهي الأمر بأن يتزوج المغنية الجميلة.

القصة بسيطة ومناسبة لعمل موسيقي كما يقولون “من الجلدة للجلدة” نسمع ونستمتع في الفيلم ربما بكل أشكال الغناء الشائعة في ذلك الوقت دون أن نشعر أن الأغاني مقحمة على الفيلم، فالفيلم يدور في أجواء المسارح المصرية الشعبية التي انتشرت في النصف الأول من القرن العشرين، وكانت مصر قد عرفت المسرح آخر القرن الثامن عشر، وفي القرن التاسع عشر أنشئت دار الأوبرا الخديوية ومسرح آخر بالأزبكية، وشجع الخديوي إسماعيل الفرق المحلية فنشأ نوع من المسرح على يدي (يعقوب صنوع) المصري و(خليل قباني) المولود بدمشق لأسرة من أصل تركي، وللمصادفة فإن شخصيتين تظهران في الفيلم كشريكين في إدارة المسرح أحدهما مصري يؤدي دوره (عبدالفتاح القَصْري) والآخر شامي لبناني يؤدي دوره (إلياس مؤدب) وأصوله ترجع إلى حلب بسوريا، وكأن الفيلم يعيد صياغة تاريخ المسرح المصري. ويبدو الفيلم كما لو كان أوبريتًا طويلًا يقدم فنون العرض المسرحية من رقص ومونولوجات وتمثيل وألعاب بهلوانية وأغنيات بكل أنواعها حتى إن الفيلم، رغم طابعه الفكاهي؛ يحوي أغنية ذات طابع قومي تقول كلماتها:
“إحنا عرب
.. وقلوبنا واحدة كلنا
حب العروبة والعرب في دمنا
إخوات مفيش.. واحد غريب.. يقدر يفرق شملنا”
فيلم مبهج بكل معنى الكلمة، يناسب تمامًا اسمه المرتبط بليلة العيد رغم أن ليلة العيد نفسها كمجال زمني تغيب تمامًا عن الفيلم لكن روحها حاضرة من خلال الموسيقى والغناء والكوميديا التي اشتهر بتقديمها المخرج حلمي رفلة والذي احتوت قائمة أفضل مائة فيلم كوميدي مصري على ثلاثة من أفلامه واشتملت قائمة أفضل مائة فيلم غنائي مصري على خمسة من أفلامه رغم شح هذا النوع الأخير من الأفلام في السينما المصرية، مما يدل على هذا التميز، والقائمتان أطلقهما مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بمشاركة نخبة من النقاد.
لا يغيب عنا أيضًا ما أضفته ألحان الأغاني التي ألفها محمود الشريف من روح احتفالية، وتصوير عبدالحليم نصر الذي تميز بأسلوبه المستمد من سينما هوليود الكلاسيكية التي تعمد لإظهار كل شيء وكل شخص في أبهى حالاته، والملابس والديكورات، والإيقاع الذي ضبطه بمهارة فائقة أستاذ المونتاج كمال الشيخ الذي صار أيضًا واحدًا من أهم مخرجي السينما المصرية.
إذا كانت ليلة العيد في فيلم الأربعينيات غير موجودة لكنها حاضرة؛ العكس هو الحال في فيلم عام ٢٠٢٤م. الذي يحمل نفس الاسم مع عنوان جانبي آخر هو ثورة النساء. الأحداث تدور في ليلة العيد لكن فرحة العيد وبهجة العيد غائبة تمامًا. إنها ليلة.. غير بيضاء.
تدور الأحداث في جزيرة تبدو واقعية لكنها رمزية إلى حد بعيد، وإلا فكيف نتصور أن كل هذا الألم والوجع والدناءة اجتمعوا في مكان واحد إلا إن كان الشيطان بذاته أسسه ليكون مقره الدائم على الأرض.
الجزيرة لا يحدد الفيلم مكانها وإن كنا لا بد أن نعتبرها موجودة وسط النيل طالما أن الفيلم مصري، لكن صناع الفيلم لم يعطوها اسمًا بل أشير إليها على أنها (جزيرة) فقط، وهذا يؤكد البعد الرمزي وأن الفيلم لم يقصد إلى رواية حكاية عادية.
مكان واحد مغلق على سكانه الذين صاروا ضحايا عزلة قديمه، كأنهم البشر أو ما آل إليه البشر في ظل نظام يسيطر فيه الرجل، ليس لأنه الأقوى بل ولا حتى قوي من الأساس، فقط لأنه مضطر لذلك.يفسر الحوارُ ذلك على لسان أحد الرجال بعد أن يتعاطى المخدرات وسط أصدقائه مبررًا تعديه بالضرب على زوجته وحلقه شعرها بالكامل فيقول: “ما أنا لازم أحكم.. لو ما حكمتش أتْحِكم”. ذلك منطقه؛ لأنه يشعر بالضعف يواري سوأته تلك بممارسة العنف كي لا يعطي زوجته مساحة لفهم قدراتها، ومعرفة مواطن قوتها، لكن فيما يبدو أن بعضهن عرفن ذلك، والمعرفة قوة، ويكون بمقدور (عزيزة) التي تؤدي دورها الفنانة يسرا أن تقود ثورة النساء آخر الأمر وهي تقول عن زوجها: “كل يوم، من يوم ما اتشل، بيصبحني ويمسيني بعلقة.. بسبب ومن غير سبب.. وأنا لو مسكته هفعصه تحت رجلي”. إن البطلة في هذا المونولوج الدقيق تشرح القضية؛ إنها ليست قضية رجل وامرأة، ليست الذكورية البيولوجية التي يتمسك بمفهومها البعض، لكنه الضغط الذي يولد العنف، الزوج الذي يقع بين مطرقة محبته لأسرته ووعيه وضغط زوجته عليه في اتجاه، وسندان طاعة الأم الواجبة وضغطها عليه في اتجاه مضاد ينتهي به الضغطان للتعامل بعنف مع زوجته. والرجل الذي أصابه مرض أقعده دون أن يكفل له المجتمع معاش تقاعد يحفظ له كرامته؛ يهين زوجته باستمرار، والأب الذي يعاني اقتصاديًا يضغط على ابنته ويحاول إثناءها عن حلمها بأن تصبح بطلة أولمبية، وهكذا قصص عديدة أخرى وفيها جميعًا تتراكب الضغوط وتنتهي بأن تثور النساء كرمز لثورة عامة في المجتمع، لكن فيما يبدو أنهن لم يكن بمقدورهن البقاء في الجزيرة فتقررن تركها.
ربما أيضًا لأنهن أدركن كونهن قويات بذواتهن؛ فتركهن الجزيرة ببلاويها لن يضرهن بل المتضررون هم أولئك الرجال المتسلطين الذين انتهى بهم الأمر واقفين على الشاطئ لا حول لهم ولا قوة بينما نساؤهم غادرن بالمركب الذي هو وسيلة الانتقال إلى البر الآخر دون أن تعبأن بكون المركب الذي فررن به قد لا يكون آمنًا تمامًا. في لقطة عابرة لكنها ذات مغزى تظهر إحداهن تحمل وعاء تنزح به ماء تسرب على مركبهن، لكنهن مستمرات في التجديف بكل عزمهن ليبعدن عن الجزيرة.
الفيلم لا يركز على محور سردي واحد، بل يعدد القصص التي تبدو كلها بالأهمية ذاتها، وهي أداة وظفها دائما سامح عبد العزيز في أفلامه خاصة أفلامه مع أحمد عبدالله التي تدور كلها في حيز ليلة واحدة وهي: (كباريه) ٢٠٠٨م. (الفرح) ٢٠٠٩م. (الليلة الكبيرة) ٢٠١٥م. (ليلة العيد) ٢٠٢٤م. هذه الأداة التي ساهمت في تحقيق الإيقاع السريع الذي يميز هذا المخرج، فهو يجعل المشاهد في حالة لهاث دائم من أول الفيلم لآخره، ربما لأن لديه فهمًا راسخًا للإيقاع اكتسبه من كونه في الأصل مونتيرًا درس ومارس المونتاج قبل أن يقدم على الإخراج.
نجحت معظم، أو لنقل كل أفلام عبدالعزيز التي تدور في ليلة واحدة بإيقاعها اللاهث وتفاصيلها المتعددة، إلا هذا الفيلم، فيلم الليلة الكبيرة فقد كان مخيبًا للآمال ولم يحقق في شباك التذاكر النجاح المرجو. هل كان ذلك لأسباب إنتاجية أم لتغير ذائقة الجمهور؟ ربما، لكن المؤكد أن السوداوية الشديدة والمواضيع الشائكة التي أسهمت في تصنيف الفيلم +١٦ جعلته غير مناسب لصالات العرض.
حاول الفيلم تكثيف الحديث عن كل ما تعانيه المرأة، ليس في مصر فقط ولا في المنطقة العربية فقط، لكن في كل العالم من عنف وقمع وتضئيل، ووسط هذه الأعباء كان لا بد لمدير التصوير جلال الزكي أن يلتزم بطبقة إضاءة منخفضة، أجواء قاتمة وألوان كئيبة عكس الألوان الخادعة التي نجدها في أفيش الفيلم الذي كان إلى حد بعيد مبهجًا ذا ألوان زاهية متشبعة مثله تمامًا كألوان أفيش الفيلم الذي أنتج في عام ١٩٤٩م. الأجواء التي خلقها مدير التصوير أسهمت إلى حد بعيد في تكثيف الإحساس بالكآبة وهو أمر كفيل بصرف مشاهدي صالات العرض. لكن علينا أن لا نعتمد هذا مقياسًا للنجاح.
خمسة وسبعون عامًا تفصل بين الفيلمين، ويبدو المجتمع كأنه مجتمع آخر. قد يبدو أكثر قتامة، لكن الحقيقة ربما تكون مختلفة، فنحن أمام مجتمع لديه القدرة على نكئ جراحه ومناقشة قضاياه بثقة ودون خوف، وأمام سينمائين يقدِّرون أن السينما لا تُصنع فقط للترفيه، وإن كانت جودة الصنعة شيئًا جيدًا على كل حال.